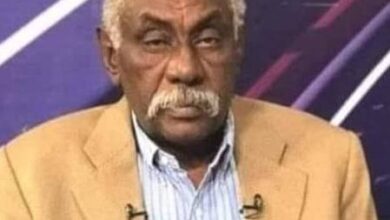أحمد ود اشتياق .. يكتب .. الدولنجية حين تصبح الحرب شعارًا لحماية سلطة لا دولة !
نعيش في لحظة يتقدّم فيها الزيف كحقيقة، والخديعة كواجب وطني

نعيش في لحظة يتقدّم فيها الزيف كحقيقة، والخديعة كواجب وطني.
وفي قلب هذا الزيف، تتقدّم سردية خطيرة تربط بين بقاء الدولة وانحياز الجيش، وتقدّمه كالممثل الوحيد والضامن الأوحد لكيان الوطن ووحدته.
هذا الخطاب لا يكتفي بتجميل الحرب، بل يستخدمه البعض لتخوين كل من يطالب بتحول مدني أو تفكيك بنية الاستبداد. يظهرون في المشهد كأنهم حراس الدولة وحدهم، ويصوّرون أي رأي مغاير كتهديد مباشر لكيانها. إنها عملية تزييف وعي محكمة، لا تهدف لحماية الدولة، بل لاختطافها.
لكن هذه السردية، في جوهرها، كاذبة. فالتجربة التاريخية تثبت أن الحرب لا تحمي الدول، بل تقوّض وجودها. وأن من استخدموا السلاح ضد الدولة هم أنفسهم من يدّعون اليوم أنهم حماتها.
خذ مثلًا: الإسلاميون الذين يتغنون اليوم بـ”معركة الكرامة”، كانوا في طليعة من قادوا حملات مسلحة لتقويض الدولة الحديثة في السودان.
عام 1976، دخلوا الخرطوم مع القوى السياسية الأخرى بقوات مدججة بالسلاح، قادمة من ليبيا، في محاولة انقلابية ضد نظام نميري. ووقعت حينها معركة شهيرة في دار الهاتف لا يزالون يحتفون بها، بل ويغنون نشيدها في حربهم الراهنة، وكأنهم لم يكونوا في تلك اللحظة أعداءً لما يسمونه اليوم “الدولة”.
الحقيقة أن الإسلاميين لا يؤمنون بالدولة الوطنية الحديثة كما نشأت في التاريخ السياسي المعاصر: الدولة بوصفها كيانًا ذا حدود جغرافية واضحة، وسيادة قانونية، ومصدر شرعية شعبي.
بل هم ورثة لمشروع فكري يقوم على مفهوم “الطليعة المؤمنة” كما صاغه سيد قطب، يؤمنون بالأممية الإسلامية وبفكرة “الأمة” المجردة، لا “الدولة”.
لذا، فإن علاقتهم بالدولة ليست إلا استعمالًا براغماتيًا مؤقتًا: يرفعون شعارها حين تكون أداة في يدهم، ويكفّرون بها حين تعيق مشروعهم.
لا غرابة أنهم حملوا السلاح ضد الدولة تحت شعار “المقاومة”، ثم استولوا على مفاصلها لاحقًا حين سنحت لهم الفرصة. وكانوا أول من دمروها من الداخل عبر التمكين والفساد حين حكموها. وها هم اليوم يعيدون نفس الدورة، لكن بلغة أكثر خُبثًا تحت لافتة “الحفاظ على الدولة”، فيما هي في الحقيقة مجرد محاولة لاستعادة سلطتهم، ولو على أنقاض الوطن.
واختزال الدولة في الجيش، كما يروّجون، ليس فقط خطأً سياسيًا، بل مصادرة لفكرة الدولة نفسها.
لأن الدولة لا تُختزل في سلاح، ولا في خطاب عسكري. الدولة هي عدالة، مؤسسات، توازنات، تمثيل متساوٍ لجميع مواطنيها.
أما الجيش، فهو أحد أدوات الدولة، لا كيانًا قائمًا بذاته.
حتى في تجارب عالمية واضحة، لم يؤدِ سقوط الجيوش المستبدة إلى انهيار الدولة.
في الأرجنتين، حين سقطت الديكتاتورية العسكرية، عادت الدولة أقوى بمؤسسات مدنية، وبحياة سياسية حقيقية.
وفي إثيوبيا، رغم صعوبة المرحلة، لم تتبخر الدولة بسقوط نظام منغستو، بل بدأت مرحلة جديدة من التكوين الوطني.
بل إن سقوط الجيش المستبد، كان شرطًا ضروريًا لإعادة بناء الدولة على أسس مدنية ديمقراطية.
لذلك، فإن كل المزايدات التي تساوي بين بقاء الدولة وبقاء الجيش، ما هي إلا محاولات لشرعنة الهيمنة بالبندقية، ووأد الديمقراطية تحت بنادق العسكر.
أما اتهام رافضي الحرب بأنهم يسعون إلى “تفكيك الجيش”، فهو كذب مفضوح.
الحقيقة أن التفكيك الحقيقي يكمن في وجود تنظيمات أيديولوجية داخل المؤسسة العسكرية، تمارس العمل السياسي باسم الجيش، وتقحم البلاد في حرب لا تخدم إلا مشروعًا سلطويًا ميتًا بأمر ثورة شعبية عظيمة .
ما يطالب به الثوار، وما تهتف به شعاراتهم، واضح لا لبس فيه:
“العسكر للثكنات، والجنجويد ينحل”.
وهذا ليس تفكيكًا للجيش، بل تحرير له من التسييس، وبناء جيش قومي يمثل الجميع، ويخضع لسلطة مدنية دستورية، لا يتغوّل عليها، ولا يحتضن مليشيات، ولا يوجه سلاحه إلى صدور شعبه.
من أراد الحفاظ على الدولة، لا يخوض حربًا في قلب المدن.
من أراد الدولة، لا يخيّر الناس بين الدبابة وحكم البندقية .
من أراد وطنًا، لا يغني للبندقية وهو يقصف بها أحلام الناس ” المجد للبندقية” .
الحرب ليست طريقًا لبناء الدولة، بل نفيٌ لها.
والخطاب الذي يقول “الجيش هو الدولة” ليس إلا إعادة إنتاج لنفس المعادلة القاتلة:
“إما نحن… أو لا دولة!”
وهذا أخطر ابتزاز يُمارس على الشعوب.
لكن بعد كل هذا الموت والتجارب وخوض ثورة عظيمة ، لم يعد الناس يُخدَعون، ولا يقبلون الابتزاز باسم الوطنية.
بقاء الدولة لا يكون بالحرب، بل بإيقافها.
ولا يُضمن بالبندقية، بل بتحقيق الانتقال المدني الديمقراطي.
ولابد من التحول المدني وإن طال السفر