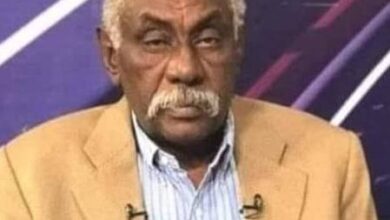فايز الشيخ السليك .. يكتب.. استقلال السودان.. الزيف والحقيقة!

ابتسمتُ عندما قدم لي مشرفي في الشركة التي أعمل بها التهنئة بمناسبة (( عيد ميلادي )) الافتراضي، لم أودُ قطع حبل دهشته بسبب فرادة تاريخ الميلاد المصادف الأول من يناير.
لم أخبره بأنَّ هذا التاريخ زائف، لا اليوم حقيقي، ولا الشهر صحيح ولا السنة كذلك، لكن كل ما أذكره أنه في أحد أيام الشتاءات القارصة في سودان ثمانينات القرن الماضي ذهبنا مجموعة من أولاد القرية إلى الخرطوم، لاستخراج ” شهادات التسنين”، حيث اكتفى الطبيب بالنظرة إلي الطفل الواقف أمامه، وفتح فمه، ثم كتابة تاريخ الميلاد تقديراً، ربما يكون أحدنا أصغر سناً لكنه طويل القامة فيكتب له القومسيون الطبي ميلاً أكبر منا، أو العكس.
هي حكايات من تواريخ ميلاد كثيرين؛ غالباً ما تكون تواريخ زائفةً مثل أشياء كثيرة عندنا، كقول الشاعر ، وغناء المغني..
كرري تحدث عن رجالٍ كالأسود الضارية..
خاضوا اللهيب وشتتوا كتل الغزاة الباغية..
ما لان فرسانٌ لنا بل فرَّ جمع الطاغية..
وهو على غير حقيقة الوقائع التي حدثت في معركة كرري في سنة ١٨٩٨، التي ولج الاستعمار عبر بوابتها، وأسس دولته” الكوليونالية” بعد ترسيم خطوط السكك الحديد، والسعي لتحديث الحياة السائدة وقتها، وتأسيس بعض المشاريع الزراعية الكبرى كمشروع الجزيرة بغرض تصدير قطنه إلى مصانع لانكشير في بريطانيا العظمى، ولنستورد نحن ذات القطن ” أقمشةً وثياباً لندنية وسويسرية؛ ونظل ندور في تبعية إلى يومنا هذا، ونحن نحتفل بذكرى الاستقلال التاسعة وستين مع أنه استمرار لذات أسس ونهج الدولة التي أسسها المستعمر.
وردت تعريفات الدولة في الفكر السياسي، و في علم الاجتماع، وفي مفاهيم التنمية منذ أن بدأ الإنسان يفكر في تأطير علاقته مع الآخرين، لتحقيق مصالحه، ومصالح أسرته، وعشيرته، وقبيلته، حال وجود آخرين يختلفون عنه في تلك الكيانات الأسرية والعشائرية والقبلية، وهي كيانات تربط المجتمعات المقيمة داخل حيز جغرافي معين، وترتبط مصالحها ببقائها على وئام، أو توافق على حد أدنى من التعايش.
وظهر المصطلح قبل آلاف السينين في الفلسفة الأغريقية، بجمهورية أفلاطون، ” يوتوبيا”، وهي نظرة مثالية مستندةً على كيان يتم تقسيمه إلى حاكم فيلسوف، وحراس مساعدين، وعمال يدويين، فيما جاءت رؤية الفيلسوف الإسلامي الفارابي في مدينته الفاضلة ترجمةً لفلسفة افلاطون والتأكيد على دور الأخلاق في السياسة، ثم كانت رؤية ابن خلدون القائمة على العصبية، في تقسيم المجتمعات، إلا أن نقلةً نوعية شهدتها أوروبا ؛ لا سيما بعد أن طوت حقبة الانحطاط الفكري، ودحرجت أركان الدولة الدينية ” الثيوكراتية”، أو الكهنوتية”.
يرى المفكر العربي الدكتور محمد عابد الجابري أن ” النظريات الأوروبية حول الديمقراطية وحول المسألة الاجتماعية وحول العلاقة بينهما كانت نظريات تؤطِّرها وضعية تاريخية معينة قوامها جملة أسس وأركان من أهمها ما يلى: وجود الدولة الوطنية القومية، وجود بنى صناعية حديثة متنامية، وجود طبقة برجوازية متمسكة بالقيم اللبرالية، وجود طبقة عاملة يتزايد عدد أفرادها يوماً بعد يوم، وجود أحزاب تؤطِّر الأفراد وتتقاسم النخب ” ، ويضيف ” أنَّ اختفاء القبيلة وذوبانها ” فى المجتمع الأوروبي” كإطار يستقطب ولاء الأفراد كان شرطاً لقيام نوع آخر من الولاء هو التبعية للسيد الإقطاعى أولاً ثم للحزب أو النقابة بعد ذلك”.
يضطَّر الأفراد في أي مجتمعٍ اضطراراً طبيعياً إلى البحث عن كيانً ينتمون إليه، وتتنوع الكيانات من سياسية إلى مدنية أو نقابية، وروابط ثقافية وفنية وأدبية، ، وهي أوعية مهمة لاستيعاب طاقات الأفراد فيها، ولاشباع غرائزهم الاجتماعية والحاجة إلى الانتماء، كخطوة مهمة من خطوات تحقيق الذات، فراعي الأبقار سيكون سعيداً لوجود اتحاد رعاة يقاسمه همومه اليومية والحياتية، والمزارع في حاجة إلى اتحاد مزارعين لمتابعة مشاكل الزراعة، وهناك من يبحث عن منظمة تدافع عن حقوق الإنسان، أو تقديم الخدمات الطوعية، وهناك من يسعد بالاشتراك في نادي رياضي، أو جمعية ثقافية، وطلاب المدارس والجامعات يكونون سعداء حال توظيف طاقاتهم الشبابية في أنشطة يقدمون عبرها الخدمات لأهلهم، وهناك من تشبع غريزته السياسية والانضمام إلى حزب سياسي.
ويشير بروفيسورر تيسير محمد أحمد، إلى أنِّ ” الدولة ليست مجرد مؤسسة فقط أو مجرد تركيب، بل هى مركب علاقات معقد خلقته اختلافات وصراعات العلاقات الاجتماعية واشكال التنظيم الاجتماعي المتطابقة معها” .
بينما ينحى الدكتور أبكر آدم إسماعيل، منحىً ثقافياً في تعريفه لعلاقات المجتمعات السودانية مع الكائن المسمى الَّدولة، ويقول ” إن السُّودان دولة مصنوعة وقصيرة التجربة – أقل من قرنين منذ قيام الدولة الحديثة فيه – وهذه الدولة الحديثة مجرد شكل تم إلباسه على مجتمعات تقليدية مختلفة ثقافياً ، ومتفاوتة تاريخياً تم جمعها حسب مقتضيات خارجية متمثلة فى مصالح الاستعمار وتوجهاته فى الأساس، ولما ذهب الاسىتعمار خلف شكل الدولة وراءه لهذه الكيانات للتنازع حوله كل بأسلحته القديمة، التى ليس ن بينها مالك لافق يستوعب ضرورة التوازن من أجل التعايش السلمى”.
إنَّ الدولة بمعناها المفاهيمي والوظيفي، عبارة عن كيان محدد، يقع داخل رقعة جغرافية يسكنها أناس يحملون موروثاً حضارياً مشتركاً ، ويوحدهم المصير ، والمستقبل، والمصالح المشتركة، و يمكن تحديد هوية هذا الكيان بمدى فاعليته في رسم خطوط هندسة اجتماعية، تضع حدوداً بين الهياكل المعنية بالتشريع، والقضاء، والحكم، والخدمات ، وتوفير الأمن، للأفراد، والمجتمعات في داخل هذا الكيان، وفض النزاعات فيما بينهم، ويشترط لفاعلية هذا الكيان هيكلته على أسس ديمقراطية، تراعي قيم المساواة والعدالة الاجتماعية، وتوفر شروط الحرية، للجميع، دون تحيز إثني، أو ديني، أو طبقي.
نجد أنه بمفهوم الدولة الحديثة أن ثمة أحداث متتالية فضحت هشاشة ما يمكن تمسيته ” دولةً ” في السودان، ومن ضمن هذه الأحداث؛ انفصال الجنوب في يناير 2011، وتفاعلاته وكشف مقدار شرخ الوجدان الجمعي، واقتراب انهداد المعبد فوق رؤوس الجميع ، هذا يمكن الانتباه إليه كذلك في سلسلة الحروب المستمرة منذ عشية ” الاستقلال ” في عام ١٩٥٥ في مناطق الجنوب الجديد بالنيل الأزرق ، وجنوب كردفان، ودارفور، وشرق السودان نهايةً بالحرب العبثية الحالية، وهو أمرٌ جدير بالتوقف عنده، لماذا الحروب المتكررة؟ ولماذا الفشل في استدامة نظام سياسي رغم مرور سبعة عقود على ” الاستقلال؟
لم يعرف السودان عبر تاريخه مفهوم الدولة القومية بمؤسساتها الحديثة، إلا في القرن التاسع عشر، حيث بدأت في التشكُّل مع بدء الحملة التركية المصرية لاستعمار السُّودان من أجل ” المال والرجال”، وكانت الأرض الممتدة من جنوب مصر حتى حدود كينيا واوغندا جنوباً، واثيوبيا واريتريا شرقاً، وتشاد وليبيا غرباً عبارة عن دويلات صغيرة، مثل السلطنة الزرقاء، وسلطنة الفور ، والمسبعات، وفي غرب البلاد نشأت سلطنة الفور في الفترة من 1445 م – 1874 م”، وظلت وحدة منفصلة لا رابط قومي لها مع الشرق والشمال والجنوب، وظلت السلطنة عصية على الاستعمار لأكثر من عشرين عاماً، حتى تمكن الزبير باشا “أحد تجار الرقيق المشهورين في مناطق بحر الغزال من هزيمة الفور وضم سلطنتهم “رمزيا”.
دخل الأتراك والمصريون السودان سنة ١٨٢١، وفشل الاسىتعمار التركي صعوبات في بناء دولة حديثة فوق أرض بلاد مترامية الأطراف، متنوعة المناخات، ومختلفة التضاريس، إلا أن الأتراك أسسوا نظماً إدارية باستجلاب موظفين وعمال أوروبيين، وأتراك، ومصريين، كما اعتبروا اللَّغة التركية لغة التواصل والعمل، مع وجود ضعيف للّغة العربية.
تفجَّرت الثورة المهدية سنة 1881 ، كحركة مقاومة شعبية، ونجحت في توحيد قطاعات واسعة من السودانيين تحت زعامة الإمام محمد أحمد المهدي، الذي توفي بعد أن أنهى الحكم التركي بعد أشهر قليلة ليخلفه خليفته عبد الله التعايشي، وقد اختلفت أسباب اخضاع المهدي للمجموعات المتباينة تحت سيطرته، مع التأكيد أنه لم يكن يحمل مشروعاً وطنياً يحدد شكل الدولة وطبيعتها وحقوق المجموعات الاثنية.
كانت أبرز ملامح الفترة المهدية قيام دولة إسلامية ضعيفة فاقدة السيطرة على الأطراف وسط حروبات أهلية، ونمو صراع ذو منحى عنصري قائم على ثنائية ” الأشراف”، و” الغرابة” أو ” أولاد البحر”، و”أولاد الغرب”، وهي نزعة تعكس ثنائية مستمرة في السودان، وبالطبع فإن الخليفة التعايشي فشل في فرض سلطته المركزية بسبب الحروب الداخلية والخارجية.
لقد أمضى الخليفة عبد الله ، معظم فترة حكمه في خوض حروبٍ داخلية بغرض اجبار مجموعات قبلية للاذعان لحكمه ولفكرة المهدية، لقد حارب الخليفة الكبابيش ، والداجو ، والمساليت، والفور، هذا عدا خلافاته الكبيرة مع “الأشراف” ” وبالرغم من يمين الولاء الذي أقسمه كل من ” الأشراف” و”اولاد البحر” فإنهم لم يكونوا مستعدين للمرة بقبول حكم الخليفة عبد الله، وبادروا على الفور بالتآمر والاطاحة به باستدعاء جيش المهدي الكبير في الغرب بقيادة محمد خالد، وهو دنقلاوي من أولاد البحر، وابن عم المهدي، ومن ناحية الخليفة قد تحرك بحزم حيث عزل خالد، وأمن الجزيرة بإمدادها من الجنوب لأم درمان.
كما سعى الاستعمار البريطاني المصري لتوطيد أركان حكمه إلى ترسيخ القبلية، واثارة العنصرية الموجودة أصلاً ما بين الشماليين أنفسهم، أو بين الشمال والجنوب بواسطة سياسات “الأرض المقفولة”، وقد كان السير هارلود مايكل، السكرتير المدني البريطاني في الفترة من 1924- 1934، هو من نصح الحاكم العام السير جون مافيري بضرورة حكم السودان من بعد، بدعم السلطات المحلية والقيادات التقليدية.
نال السودان استقلاله في يناير 1956 م على طبق من ذهب” و” صحن صيني ما فيهو شق ولا طق” على حد توصيف السيد إسماعيل الأزهري أول رئيس سوداني، وكان الاستقلال نتيجة موازنات دولية دفعت بريطانيا بالتخلي عن عدد من مستعمراتها، ومن ضمنها السودان، وتم ذلك دونما تضحية كبيرة سوى من تحركات معزولة هنا وهناك أكبرها ثورة اللواء الأبيض في سنة1924، وما أفرزته من إشكالات الهوية، ومأزقها، الذي أراده بعض النخبة ” باسم الشعب العربي”، فيما أصر علي عبد اللطيف بجذوره الأفريقية ، ” الشعب السوداني النبيل”.
خرج الاسىتعمار وخلف وراءه دولة ” كولينيالية” هشة المشاعر الوطنية، ومضطربة الهوية، ويرى البروفيسور تيسير محمد أحمد علي في ورقة بعنوان ” السودان…. الاستقلال ومأزق المشروع الوطني” ” في غالب الأحوال ما يكون الاستقلال المرحلة الأولى في عملية البناء الوطني، مربوطة بالشعور بنمو الحقوق السياسية والتحرر من السيطرة. ولابد أن يتضمن، ليس فقط التخلص من المستعمر، بل التحرر الكامل من كافة العلاقات، والبنى، والهياكل، وحتى المفاهيم التي خلفها المستعمر، واستبدالها بأخرى تأطر لمشروع وطني كامل يقابل احتياجات الشعب والدولة المستقلة”.
وفي ذات السياق يرى الدكتور حيدر إبراهيم ” لم يهتم السودانيون بعد الاستقلال ببناء دولتهم الوطنية، والتي كان لا بد أن تكون دولة وطنية، ديمقراطية، تعددية الثقافات، وعلمانية أو مدنية، ولكن السودان خضع لعملية طويلة ومركَّبة لتوظيف الدين سياسياً، ابتدرته القوى الطائفية التقليدية، وأكملته قوى جديدة محافظة” الإخوان المسلمون بمسمياتهم السودانية المختلفة، ومع زج الدين في السياسة وجعله أساساً ممكناً لأي دولة سودانية قادمة، كانت هذه مقدمة لتهميش كل العناصر غير المسلمة واعتبارهم مواطنين من الدرجة الثانية، وفي هذا التوجه وأد لفكرة الدولة الوطنية الموحدة، ومن هنا أسس حكم الإسلامويين بقصد ، أو لا وعي ـ للتفكك الحتمي للدولة السودانية قبل أن يكتمل بناؤها الذي تعطل منذ الاستقلال”.
ورث السودانيون دولتهم المصنوعة من البريطانيين، فعلى مستوى نظم الحكم، لا نزال ندور في حلقةٍ جهنمية، ودائرةٍ شريرة، ويقتنص الجيش من سنوات الحكم حوالى (٥٧) سنةً من عمر الدولة، وأصبح حزباً مسلحاً، أو جناحاً عسكرياً لفئة سياسية، فشغل نفسه بالتجارة والتسابق نحو كراسي الحكم فبلغت عدد الانقلابات العسكرية أكثر من عشرين محاولةً؛ كأكبر عددٍ انقلابات تشهدها أفريقيا، ويحل السودان عالميا في المرتبة الثانيةً بعد بوليفيا، فيما تعاني القوى السياسي من حالة كساح أعجزتها من الممارسة الديموقراطية الحقة، وأغرقت نفسها في ” الديموقراطية الإجرائية”.
واستمرت ذات السياسات الاستعمارية اقتصادياً، إذ لا نزال نزرع الأقطان ونصدرها إلى الصين، ونستورد في ذات الوقت الجلاليب والثياب، ونصدر الماشية الحية ونستورد منتجاتها أحذيةً وحقائبَ جلدية، ونصدر السمسم والفول، ونستورد زيوتاً وأعلافاً وطحنيةً.
وعلى المستوى الإداري لا نزال نحتكم في الأطراف والهوامش إلى إرادة الإدارات الأهلية والزعامات القبلية بذات طريقة إدارة المستعمرين الذين فضلوا منح الامتيازات لتك القيادات وتوكيلها للحكم بالإنابة.
تواصلت الحروب في السودان؛ إلا أن الحرب الأخيرة كانت قشةً قصمت ظهير بعير دولة مصنوعة، فاقدة للأوتاد مع كثرة الزوابع التي تواجهها، ويكفي الإشارة إلى ترك أكثر من ربع السكان منازلهم وقراهم ومدنهم، مولين هاربين إلى جبالٍ تأويهم من طوفان جرائم المتقاتلين لا سيما قوات الدعم السريع، و أصبحت الخرطوم خاوية على عروشها تسكنها الأشباح، لدرجة عجز قادة الطرفين المتقاتلين في العيش تحت ركامها، وانهار مع ذلك القطاع الصحي العليل، والتعليمي الكسيح، وقطاع الخدمات الهش.
وفضحت كذلك ضعف مخيال النخب التي توارثت حكم هذه البلاد بلا خطط تنموية في الأصقاع النائية وحتى القريبة من مركز القرار والخدمات وحذب الناس، فلا مدارس في الأقاليم تكون بديلةً لطلاب المناطق المتأثرة بالحرب، ولا بنى تحتية تستضيف طلاب الجامعات، ولا ملاعب رياضية حتى صارت أنديتنا الرياضية ومنتخباتنا الوطنية معلقةً بين أجواء جوبا ونواكشوط وطرابلس ودار السلام.، وكشفت وجهاً قبيحاً للإنسان السوداني تمثل في محاولات الاستغلال الفاحشة للنازحين والباحثين عن مساكن تأويهم من خطر التسول وكارثة النزوح، حيث ضرب كثيرون ما كنا نحبه من قيم التكافل والمحبة والترابط الاجتماعي بيننا كسودانيين.
لقد بيَّنت حرب أبريل عمق أزمة الدولة الوطنية وضعف الرابط القومي، وانتزعت ورقة التوت عن بعض من الاستحياش المتخبئ وراء سماحة زائفة مثل شهادات تسنينا، واستسهال القتل والنهب وانتشار خطاب الكراهية، ونتج هذا بسبب فقدان مشروعٍ وطني يكون معبراً عن الجميع ثقافياً وروحيا، ومادياً، بل أنَّ الحرب اللعينة أوضحت وهن الكيان الجغرافي الجامع، بهياكله المتحللة، وأكدت أنَّ السُّودان لا يزال كياناً أُلبس لباس الدولة الحديثة قسراً.