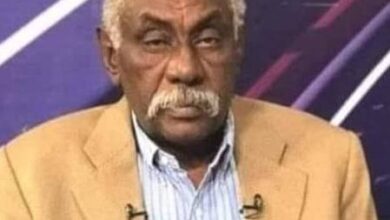بابكر فيصل بابكر .. يكتب .. عن ” الملتقى السوداني حول الدين والدولة “

أُتيحت لي أواخر شهر فبراير الماضي فرصة المشاركة في “الملتقى السوداني حول الدين والدولة” الذي نظمه “مشروع الفكر الديموقراطي” بالإشتراك مع “منتدى إيلاف للحوار والتنمية” بالعاصمة الكينية نيروبي.
وقد قُدِّمت في الملتقى العديد من الأوراق الهامة حول الموضوع, وكان من بينها الورقة التي قدمَّها الأستاذ مبارك الكودة بعنوان “تجربتي الشخصية في الحكم”, وتنبع أهمية الورقة من أن كاتبها ظل عضواً ملتزماً داخل صفوف جماعة “الأخوان المسلمين” لعقود طويلة كما أنه شارك بفعالية في تثبيت أركان نظام حكم الإنقاذ عبر تقلد العديد من المناصب التنفيذية, وبالتالي فإنَّ تقييمه للتجربة يأخذ أهمية خاصة.
كنتُ قد أشرت في مقالات سابقة إلى أنَّ الأستاذ الكودة يعتبر من أكثر قيادات الأخوان المسلمين جرأة ومصداقية في إنتقاد تجربة الحكم, ليس لأنه سعى دون مواربة لإبراز الإخفاقات الكبيرة التي صاحبتها فحسب, ولكن لأنه أيضاً عمل على كشف الخلل في “المنطلقات النظرية” التي أدت لتلك الإخفاقات.
حاولت الورقة الإجابة على السؤال ( لماذا حدثت هذه المفارقة الكبيرة في التجربة بين الواقع والمثال النظري ، خاصة وأن التجربة قد توفرت لها كل مقومات النجاح من فترةٍ زمنيةٍ كافٍية و كادرٍ مؤهلٍ لم يتوفرا لأي حكومة سابقة في السودان ؟ ).
تناول الأستاذ الكودة في البداية تجربة “المشروع الحضاري” وهو الموضوع الذي كتبنا حوله كثيراً وقلنا أنَّ الذين سعوا لتطبيقه لم يكونوا يعرفون ماهيته وكنهه إبتداءاُ , ولكنهم إنساقوا وراء شعارات من شاكلة “الإسلام هو الحل” بإعتبار أنَّها شعارات سحرية تنطوي على الحلول الناجعة لجميع المشاكل التي تعاني منها مجتمعات المسلمين.
قال الأستاذ الكودة ( جئنا للحكم بلا تجربة عملية سابقة لتأسيس دولة إسلامية بمقومات الحداثة ، تحت شعار الإسلام هو الحل ، دولة تخضع لنظام عقدي سياسي ، مع أني لم أقف علي تعريف متفق عليه للدولة في الإسلام السياسي ، ولكن عرّفت الحركة الإسلامية مشروعها بإسم ( المشروع الحضاري ) وهو مصطلح للإسلام الشامل ، لذلك لم يكن المشروع الحضاري ﻣﺸﺮﻭﻋﺎً ﻭﺍﻗﻌﻴﺎً ، ﺑﻞ هي أشواق ﻭﺃﻣﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻟﺬﻳﻦ جاءوا به ﻭتَجسّدَ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺘﻲ ﻣﺸﺮﻭﻉٌ وحضاري !! وﻣﺎﺫﺍ ﺗﻌﻨﻲ ﻫﺎﺗﻴﻦ ﺍﻟﻜﻠﻤﺘﻴﻦ ؟ ﻭﻛﻴﻒ ﻳﻨﻔﺬ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ؟ ﻭﻣﺎﻫﻲ سماته ﻭأدواته ﻭﻟﻮﺍﺯﻣﻪ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ؟ ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻭﻏﻴﺮ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ، ﻭلقد ﻇﻠﻠﺖ مع ﺍﻹﻧﻘﺎﺫ ﻗﻴﺎﺩﻳﺎً ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺎً ﻣﻨﺬ ﻗﻴﺎﻣﻬﺎ ، ﻭﻛﻨﺖ ﻣﻬﻤﻮﻣﺎً جداً ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍلاجتماعي ، ﻭﻟﻜني ﻟﻢ أقف ﻋﻠﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻭﺍﺿﺢ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻢ ﻟﻤﺼﻄﻠﺢ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻱ !! ﻛﻤﺎ ﻟﻢ أجد ﺷﺨﺼﻴﻦ ﻓﻲ ﺳﻔﻴﻨﺔ ﺍﻹﻧﻘﺎﺫ ﻳﺘﻔﻘﺎﻥ ﻋﻠﻲ ﻣﻌناه !! فكل منا يقدسه وﻳﻔﺴﺮه ﻭيُجسّده علي أرض الواقع ﻭﻓﻖ ﻫﻮﺍﻩ ﻭاجتهاداته ﺍلخاصة ) . إنتهى
ثم يُصيف : ( ظل ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍلهلامي أثناء الممارسة ﻳﻔﺘﻘﺪ القدره ﻋﻠﻲ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﻭﺍلإنتاج ، كما ظل ﻣﺸﺮﻭﻋﺎً ﺭﺍﻛﺪاً خاملاً مستبداً ﻭعاجزاً عن تحقيق حضوره ، ﺑﻞ ﺣﻘﻖ ﻋﻜﺲ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ينبغي أن يحقق ، وقد أثبتت الممارسة العملية أننا لا نملك إجابةً لكثيرٍ من الأسئلة التي فرضت نفسها علي الواقع ، ومن ثم دخل ﺍﻟﻤﻮﺍﻃن بهذا القصور النظري ﻓﻲ ﺃﺯمات متعددة ، حيث اختلطت الأولويات ، وتراجعت الاسبقيات ، وارتبكت المفاهيم ، ﻓﺰﺍﺩﺕ ﺣﺪﺓ ﺍﻟﻔﻘﺮ ، ﻭﺍﻧﻔﺮﻁ ﻋﻘﺪ ﺍلأمن ، ﻭﺗﺸﻈﺖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺿﺎﻕ ﺍلوطن ﺑﺄﻫﻠﻪ وﺑﻤﺎ ﺭﺣﺐ ، ﻓﻬﺎﺟﺮﺕ ﺍﻟﻜﻮﺍﺩﺭ ﺍﻟﻤﺆﻫﻠﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ، ﺧﻮﻓﺎً ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻭﺍﻟﻔﺎﻗﺔ ﻭﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺴﺎﻟﺒﺔ ، كما ظل مثالنا يتحدث عن ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍلاجتماعية ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﻔﺎﺿﻠﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﺷﻴﺪﺓ ، ولكن بقيت الرؤية الأمنية هي التي تتصدر قضايا الحكم في الشأن العام مما أفقد التجربة قدرتها علي التطور للتي هي احسن ). إنتهى
تطرق الأستاذ الكودة بعد ذلك لنظرية “الحكم الباطني” التي تبنتها الإنقاذ منذ يومها الأول, وهى النظرية التي إنعكست في ثنائية “التنظيم والدولة” وما ترتب عليها من إزدواجية خطيرة أخلت بشكل العلاقة الطبيعية بينهما بحيث أصبحت هناك دولة ظاهرية هى دولة الوزارات و المؤسسات والأجهزة البيروقراطية المعروفة, وأخرى خفية هى دولة التنظيم التي عُهد إليها بتسيير كل شىء.
قال الكودة : (عُيّنت محافظاً في أول عهد الإنقاذ وبعد أدائي للقسم مباشرة إجتمع بي التنظيم وزودني بكل توجيهات العمل ، علماً بأن هنالك دولة ذات شخصية اعتبارية وقانونية ومؤسسات تشريعية وتنفيذية ، وعدت بهذه التوجيهات إلي مكان عملي في المحافظة المعنية رجلاً فيه شركاء متشاكسون ، أحدهما الدولة بمؤسساتها ، والآخر تنظيم صفوي لا سلطان له علي الناس ، ولكنه قيّم علي دولتهم من وراء حجاب ، تنظيم يحتفظ بكل قوته وهيمنته ، وتُدينُ له العضوية بكامل الولاء والطاعة ، من دون السلطان الشرعي ، وقد أدي هذا التناقض في الفكرة إلي حالة مضطربة جداً أخلت بالتوازن النفسي للدولة والحركة ). إنتهى
ثم يدلف الأستاذ الكودة لتناول علاقة الحزب بالجهاز الحكومي, حيث يوضح الكيفية التي تم بها إستغلال الأخير لخدمة برامج وأهداف الحزب دون وجه حق, كما يؤكد الحديث الذي ظللنا نكرره مراراً حول الخلل الفكري الكبير في التعامل مع “أسس البيرواقراطية الحديثة”, وهو خلل ناتج من الإعتماد الكامل على الكوابح الداخلية مثل “الإيمان” و “التقوى” و “الضمير” في تسيير شؤون الدولة وإهمال القيود الخارجية المتمثلة في اللوائح والنظم والقوانين, مما أدى لإستشراء الفساد والمحسوبية والرشوة بصورة كبيرة وغير مسبوقة.
قد تعاملت الحكومة مع خلاصة التجارب الإنسانية في إدارة الدولة بإستخفاف كبير و”عنجهية” شديدة, فذبحت القوانين, وأحكمت سيطرتها على السلطة بالكامل, وحطمت جميع الكوابح الخارجية, وأخيراً اكتشفت أنَّ منسوبيها ليسوا ملائكة, وفي هذا الخصوص يقول الأستاذ الكودة :
( بين المؤتمرالوطني كحزب سياسي والحكومة كجهاز تنفيذي علاقة زواج كاثوليكي ، وثّق عقد قرآنهما النظام الأساس للحزب ، الذي عين رئيس الجمهورية رئيساً للحزب علي المستوي القومي ، والوالي رئيساً علي مستوي الولاية ، والمعتمد في محليته ، والغرض من ذلك تسخير كَافة إمكانيات الدولة في خدمة الحزب ، وَمِمَّا نعلمه تماماً أن أنشطة الحزب من تجريدات لدعم المجاهدين لمناطق العمليات ، والمتضررين من الأمطار والسيول ، وموائد الرحمن ، والزيجات الجماعية ، وغيرها من الأنشطة التي تُنظم تحت لافتات المؤتمر الوطني المختلفة للكسب السياسي ، كانت خصماً من ميزانية الدولة, كما كنا كإسلاميين في الجهاز التنفيذي نتمتع بحصانة تنظيمية دون الآخرين ، وَمِمَّا أؤكده هنا أنه طيلة عملي كدستوري منذ العام ١٩٩٢ حتي العام ٢٠١١ لم أخضع لمساءلة أو محاسبة ولم أُخاطب من سلطان الدولة بأمر أفعل أو لا تفعل أو لِمَ فعلت ، لأننا لا نتحاكم إلي نظم الدولة و تراتيبها وأعرافها , بل نتحاكم إلي التنظيم ، ويشفع لنا أمام المساءلة تاريخنا السياسي وكسبنا التنظيمي في الحركة الإسلامية ، وهذه الحصانة جعلت لنا قيمة مضافة في الجهاز التنفيذي ، فربما تجد والٍ مستقطب جاءت به إلي السلطة الموازنات السياسية يخاف من موظفٍ منظم في الحركة الإسلامية ، بل رأينا بعضهم يسعي لإرضاء هؤلاء الموظفين تقرباً لصناع القرار ، وطمعاً في منزلة أخري ، وبالطبع ترتب علي ذلك ضياع هيبة الدولة ، وتراجع سلطانها وضعُف أداؤها السياسي ). إنتهى
ولا ينسى الأستاذ الكودة تناول “الخطاب السياسي” للإنقاذ, ويؤكد طبيعته “العاطفية” غير “العقلانية”, وتوجهه “الأممي” الذي لا يكترث كثيراً لمفهوم “الوطن”, وهو المفهوم الغائب عن المنطلقات الفكرية لجميع حركات الإسلام السياسي, وليس الأخوان المسلمين وحدهم, حيث يقول :
( ظل الخطاب السياسي للإنقاذ خطاباً عاطفياً وخيالاً مجرداً ، عبارة عن شعاراتٍ وهتافاتٍ فارقة المحتوي والمضمون تحركه الحماسة والأشواق ويفتقد للواقعية ، وكان في بداياته الأولي عالميّ التوجه ، وسعي لتجميع الحركات الاسلامية والقوي السياسية الموالية علي صعيد واحد لتكوين جبهة عالمية عريضة لمقابلة اعدائه ، مما ترتب علي ذلك آثارٍ سياسيةٍ وأمنيةٍ سالبة ظللنا نعاني من إفرازاتها وندفع ثمنها حتي الآن ). إنتهى
أمَّا نظرية التمكين التي طبقتها الإنقاذ وأدت لتدمير الخدمة المدنية والمؤسسات القومية, فقد قال عنها الكودة :
( إبتدع النظام نظرية التمكين التي هي في الحقيقة ( التسييس) فقد سُيِّست بهذه النظرية الخدمة المدنية تماماً ، مما أدي إلي إنهيار تلكم المؤسسة ذات التاريخ والتقاليد والقيم الموروثة ، واختل فيها ميزان العدالة وسيادة القانون بقرارات ظالمة ومجحفة ، وشُرِدَ جراء هذه السياسة مئات من العاملين أصحاب الكفاءات والقدرات ، بحجة أن صاحب الولاء أفضل للمشروع الإسلامي من صاحب الكفاءة ، وأصبح التنافس علي الوظيفة العامة في عمود الدولة الفقري يخضع لقانون الموالاة السياسية والموازنات القبلية والجهوية والمصلحة الشخصية ، بعيداً عن لجان الاختيار ذات الشفافية والوضوح.
( ومن وسائل التمكين الذي ابتدعته الانقاذ أيضاً قانون النظام العام ، وهو تديّن ظاهري مسرحه الشارع العام ، وباسم الإسلام إستباح هذا القانون أعراض الناس ، وهتك خصوصيتهم وشهّر ببعضهم ، وكانت السلطة تسعي من وراء هذه السياسة إلي تنميط الشخصية السودانية ، وهذا بالطبع يخالف الفطرة وتنوعها الإيجابي ، ولذا جفت منابع الإبداع ، وذابت شخصية الفرد واستقلاليته ، وغُيّبت فكرة المواطن والوطن لتحل مكانها فكرة الجماعة ذات النمط الواحد ٠
( ومن وسائل التمكين التي اعتمد عليها النظام ، تسييس الإدارة الأهلية واستقطاب القبائل لِيُقوّي بها عوده ، باعتبارها سُنَّة من سَنَن المصطفي (ص) في الدعوة ، وهذه كلمة حق أريد بها باطل وقياس فاسد ، فالفارق بينهما جدُ كبير ، فالرسول (ص) بايعته القبائل علي البراء من الكفر إبتغاء مرضاة الله ، والقبائل بايعت الإنقاذ ابتغاء مناصب دستورية ترجوها في المركز والولايات ، حتي أصبح الخروج علي السلطان سنة لِنيل حظٍ من السلطة والثروة وترتب عن ذلك أن عجزت التجربة من إدارة التنوع الثقافي في الوطن ). إنتهى
لا ينسى الأستاذ الكودة تذكير جماعته “بإزدواجية المعايير” التي صارت السمة الأكثر وضوحاً في ممارستها السياسية, فهى تُجوِّز لنفسها ما تحرمه على الآخرين, ويقول الرجل :
( كما أكدت لي التجربة أننا كإسلاميين نعتقد أن الله يغفر لنا ما لا يغفره للآخرين ، لذلك تجدنا نجتهد بإيراد الأدلة والمسوغات الشرعية والأخلاقية لأعمالنا مثل مبرراتنا لإستيلاء السلطة عن طريق الأنقلاب العسكري ، علماً بأن الحركة الإسلامية قاومت انقلاب الفريق إبراهيم عبود وساهمت في الإطاحة به عام ١٩٦٤ ، كما أعلنت منذ اليوم الأول مقاومتها لحركة نميري في ١٩٦٩ ، ثم صالحته فانقلب عليها ، فساهمت كذلك بكوادرها في الإطاحة به في أبريل 1985 .
( تجدني أستدرك علي الحركة الإسلامية هذا الكيل بالمكيالين ، تستوفي بأحدهما لنفسها ، وتخسر بالآخر للآخرين ، فإن كانت الانقلابات العسكرية تجوز بتقدير المصلحة ، فيعني ذلك أنها حكم عام لكل من يري ذلك ، وإذا كان خروجنا علي نظام مايو بالسلاح عندما دخلنا مدينة أمدرمان من ليبيا مع حلفائنا فإن ذلك بالضرورة جواز لدخول قوات الاخ المنشق خليل إبراهيم رحمة الله عليه لأمدرمان بذات الطريق ، وإذا كان إضراب الأطباء الذي قاده الإسلاميون مع آخرين في أبريل 1985 جائزاً شرعاً وأخلاقاً ، فأن ذلك يجوز لأطباء اليوم أن يضربوا عن العمل كما أضرب أولئك ). إنتهى
قد يقول البعض أنَّ الأستاذ الكودة صمت لفترة طويلة ولم يتحدث عن عيوب التجربة إلا بعد خروجه من الحزب الحاكم, وهذا الأمر في رأيى لا يقدحُ في شهادة الرجل, فالحكم في هذا الشأن يجب أن يكون على محتوى أقواله وليس موقفه الحالي من الحزب الحاكم, فإن كان هناك من يعترض عليها, فعليه الخروج على الملأ لتكذيبها.
أمَّا بالنسبة لكاتب هذه السطور فإن الإعتراف بالخطأ, في أية وقت, يُعتبرُ بحد ذاته فضيلة أخلاقية ودينية, وأن تأتي متأخراً خيرٌ من أن لا تأتي مطلقاً, خصوصاً عندما يكون الأمر متعلقاً بمصير وطن وشعب وأجيال دفعت أثماناُ باهظة من أثر تجربة الحكم الممتدة منذ ثلاثة عقود.